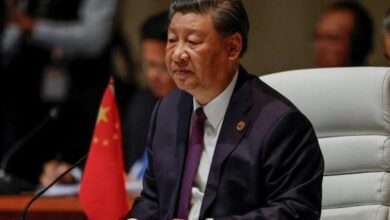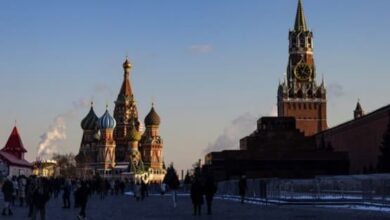كتبت: إسراء عبدالله
المصدر: مستشار بايدن للشرق الأوسط يكتب في سي إن إن
بعد أسبوعين من الضربات العسكرية الأميركية غير المسبوقة داخل إيران، هدأت الأوضاع في الشرق الأوسط، وبدأ التركيز يتحول نحو المسار الدبلوماسي.
فما الذي يتصدر جدول الأعمال العالمي؟
خلال الأسابيع المقبلة، أود التركيز على عدد من القضايا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور واشنطن في مطلع هذا الأسبوع، وقد كان كبار مساعديه في المدينة منذ أيام للتحضير.
على رأس جدول الأعمال: غزة، حيث يُعتقد أن وقف إطلاق النار بات أقرب من أي وقت مضى منذ أشهر.
الوضع في غزة كارثي. إنها حرب يجب أن تنتهي، وبأسرع وقت ممكن. ولكن إنهاء الحرب أصعب بكثير من إشعالها — وهذا درس تعلمته حماس. أما إسرائيل، فهي لم تحدد بعد مستقبل غزة من دون حماس، على الرغم من أن هذا هو مطلبها الأساسي في المحادثات الجارية.
من المستحيل الإجابة بمسؤولية على سؤال “كيف تنتهي هذه الحرب” من دون مواجهة الحقيقة الكاملة لهجوم 7 أكتوبر 2023، عندما قررت حماس غزو إسرائيل وقتلت 1200 مدني بريء، وأخذت أكثر من 250 شخصًا — أحياء وأموات — إلى أنفاقها في غزة.
منذ ذلك الحين، تمسكت حماس بمطلب وحيد مقابل إطلاق سراح الرهائن: أن تضمن إسرائيل “وقف إطلاق نار دائم” ضدها، بينما تواصل الجماعة السيطرة على غزة وتسليح نفسها — أي العودة إلى الوضع الذي سبق الهجوم. إسرائيل رفضت هذا المطلب، وردّت بالمطالبة بأن وقف إطلاق النار الدائم يجب أن يعني نهاية سيطرة حماس على غزة.
هذه هي عقدة الأزمة، وهي التي ما زالت قائمة بعد ما يقرب من عامين على اندلاع هذه الحرب المروعة.
خلال إدارة بايدن، كنتُ من قادة المفاوضات مع إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن. وبسبب عجزنا عن سد هذه الفجوة الجوهرية في المواقف، طورنا عملية مرحلية تقضي بإطلاق حماس للرهائن الأكثر ضعفًا — الأطفال، النساء، المسنّين، والجرحى — مقابل وقف إطلاق نار مؤقت وإفراج إسرائيل عن مجموعة متفق عليها من السجناء الفلسطينيين.
وكان من المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات الجدية بشأن الترتيبات التي ستلي الحرب في غزة.
وقد أسفرت هذه الاتفاقات المرحلية عن الإفراج عن نحو 150 رهينة على قيد الحياة من غزة. ويُعتقد الآن أن هناك حوالي 20 رهينة لا يزالون أحياء هناك.
في يناير الماضي، وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة، وانسحاب حزب الله من الحرب بعد التوصل إلى تفاهم خاص به، ما أدى إلى عزل حماس، وافقت كل من إسرائيل وحماس على خارطة طريق من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب بشكل نهائي.
وقد تم دعم هذه الصفقة مسبقًا من قبل مجلس الأمن الدولي، ونصّت على وجوب توفر “شروط” لإنهاء دائم للحرب في مراحلها اللاحقة. وكان المقصود بذلك أن تتخلى حماس عن سلطتها في غزة، حتى يمكن إعادة إعمارها بدعم دولي — إذ من غير المرجح أن يقدم أحد دعمًا لإعادة الإعمار ما دامت حماس في الحكم.
لكن للأسف، استغلت حماس وقف إطلاق النار الواعد في وقت سابق من هذا العام لتخرج من أنفاقها وتستعرض قوتها. وبعد ستة أسابيع من الهدوء دون إطلاق رصاصة، تم خلالها إيصال أكثر من 10 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية إلى من هم بأمس الحاجة، انهار وقف إطلاق النار بعد انتهاء مرحلته الأولى التي استمرت 42 يومًا.
وتصاعدت الحرب بعدها، رغم استمرار الجهود لعقد صفقة لإطلاق سراح الرهائن.
زخم متجدد
اليوم، هناك زخم جديد باتجاه إتمام صفقة، تقوم على نفس المبادئ التي طرحتها إدارة بايدن. وبموجب هذا المقترح، تطلق حماس سراح 10 رهائن أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، مع الإفراج بالتوازي عن سجناء فلسطينيين. وإذا كانت المحادثات مستمرة عند نهاية الفترة بشأن بقية الرهائن وشروط التسوية النهائية، فسيُمدد وقف إطلاق النار.
في 1 يوليو، أعلن ترمب أن إسرائيل قبلت بهذا المقترح. أمضت حماس الأسبوع التالي في دراسته، تحت ضغوط شديدة من مصر وقطر للموافقة عليه دون شروط. وفي 4 يوليو، قدمت حماس ردها، والذي يبدو أنه “نعم، ولكن”، مع اقتراح بمواصلة المحادثات لتوضيح أماكن انتشار القوات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، وعدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وآلية إيصال المساعدات الإنسانية.
للأسف، هذا يعني أن الحرب التي كان يمكن أن تتوقف الأسبوع الماضي ستستمر، في حين يواصل قادة حماس المتبقون — سواء في أنفاق غزة أو يعيشون برخاء في الخارج — المساومة على التفاصيل، بينما يعيش من يدّعون تمثيلهم في ظروف إنسانية لا تُحتمل.
ستُستأنف المحادثات هذا الأسبوع في الدوحة، قطر. ويأمل الجميع أن تنجح، لأنها السبيل الوحيد حاليًا لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب في غزة.
في الواقع، وعلى عكس صفقة يناير التي انهارت بعد المرحلة الأولى، فإن شروط هذه الصفقة تتيح استمرار وقف إطلاق النار بعد 60 يومًا، وربما إنهاء الحرب نهائيًا.
والسبب هو أن معظم قيادات حماس العسكرية قُتلوا، كما أن إسرائيل في موقف قوي للغاية بعد نجاح عمليتها العسكرية في إيران الشهر الماضي.
وهذا يمنح إسرائيل فرصة لإنهاء الحرب من موقع قوة، دون مخاطر جدية لتكرار سيناريو 7 أكتوبر.
ومن المؤكد أن ترمب سيضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات معقولة، بينما يواصل الضغط على أمير قطر لدفع حماس نحو قبول الاتفاق — وهي الطرف الوحيد الذي ما زال يعطل التوصل إلى تسوية.
البرنامج النووي الإيراني
رغم استمرار التقييمات بشأن حجم الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني، فإن التوصل إلى حل طويل الأمد سيتطلب نوعًا من التفاهم الدبلوماسي، وذلك لسببين رئيسيين:
أولاً، إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ولديها التزام قانوني بالإفصاح عن كافة المواد النووية وتطبيق ضمانات عليها، بما في ذلك مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب التي قد تكون مدفونة في منشأة “فوردو” التي تعرضت للقصف.
ورغم أن البرلمان الإيراني أقر قانونًا يقضي بقطع العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الحكومة الإيرانية أوضحت أنها لا تزال عضوًا في المعاهدة وستواصل التعامل مع الوكالة من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي — المعادل تقريبًا لمجلس الأمن القومي الأميركي.
وإذا رفضت إيران هذا التعاون، فبإمكان كل من فرنسا والمملكة المتحدة تفعيل آلية “العودة التلقائية” (snapback) التي تُعيد فرض جميع العقوبات الدولية والأممية بين الآن وشهر أكتوبر المقبل — وهو أمر لا يمكن للاقتصاد الإيراني الهش تحمّله.
ثانيًا، إذا أرادت إيران تجنّب خطر ضربات إسرائيلية أو أميركية إضافية، فعليها التوصل إلى اتفاق بشأن ما تبقى من برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
قبل اندلاع الصراع الأخير مع إيران، كانت الولايات المتحدة مستعدة للقبول بتخصيب محدود دون 5%، يتم فوق الأرض، في مقابل إنشاء “مصرف وقود إقليمي” يتيح لإيران الحصول على الوقود النووي لأغراض مدنية، دون أن تكون قادرة على التخصيب بمفردها.
لكن إيران رفضت هذا العرض. واليوم، ستكون الشروط أقل سخاء: لا تخصيب على الإطلاق، ولو مؤقتًا، أو مواجهة خطر المزيد من الضربات والعقوبات الدولية.
ورغم ما كان متوقعًا من أن الضربات الأميركية ستُفشل أي مسار دبلوماسي، فإن طهران أعلنت استعدادها للتواصل مجددًا مع الجانب الأميركي — وأتوقع أن تبدأ تلك المحادثات قريبًا.
ومع الخسائر الكبيرة في صفوف القيادة الإيرانية، قد تجد طهران صعوبة في اتخاذ قرارات ضرورية للتوصل إلى اتفاق. ومع التهديد باستخدام آلية “العودة التلقائية” للعقوبات، فإن ملامح طاولة التفاوض بدأت تتضح مع اقتراب مهلة نهاية هذا العام.
الهدف بين الآن وحتى ذلك الحين هو التوصل إلى اتفاق يغلق بشكل دائم الباب أمام امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.
توسيع اتفاقيات إبراهام
قبل 7 أكتوبر 2023، كانت المنطقة تتجه نحو مزيد من الاندماج الإقليمي، والتعاون الاقتصادي، والسلام.
في الواقع، قبل يوم واحد فقط من هجمات حماس، كانت وفود رسمية سعودية تجري محادثات في البيت الأبيض حول شروط اتفاقية للاعتراف بإسرائيل.
كان هذا الاتفاق يُفترض أن يُبنى على اتفاقيات إبراهام، ويضع أسسًا لسلام إقليمي طويل الأمد، بما في ذلك بين إسرائيل والفلسطينيين.
الفلسطينيون — باستثناء حماس والجماعات الإرهابية الأخرى — كانوا جزءًا من هذا المسار، وكانوا على وشك جني مكاسب كبيرة من الاتفاق مع السعودية.
وكان مسؤول سعودي رفيع قد زار رام الله — عاصمة السلطة الفلسطينية — لأول مرة منذ عام 1967.
وفي 9 سبتمبر، قبل أقل من شهر من 7 أكتوبر، أقرّت مجموعة العشرين مشروع ممر تجاري وتكنولوجي يُعرف باسم IMEC، يربط الهند بالخليج، ثم الأردن، فإسرائيل (مع خطط لربطه مستقبلًا بالضفة الغربية)، ثم إلى أوروبا.
لكن حماس وحلفاءها المدعومين من إيران أطاحوا بهذا المسار الواعد.
ومع ذلك، لم ينجحوا في عكس اتجاهه.
فالعلاقات بين إسرائيل ودول اتفاقيات إبراهام، مثل الإمارات، لا تزال قوية، وهناك رغبة واسعة في العودة إلى هذا المسار فور تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وبفضل النجاح العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي، تبدو فرص العودة لهذا المسار أكبر — إذ تتطلع الدول إلى الاستفادة من قدرات إسرائيل في الدفاع والتكنولوجيا لتعزيز أمنها ونموها الاقتصادي.
وفي إشارة إلى التغيرات الجذرية بعد 7 أكتوبر، هناك الآن دولتان جديدتان مرشحتان للسلام مع إسرائيل: لبنان وسوريا.
لبنان، الذي لا يزال رسميًا في حالة حرب مع إسرائيل، يسلك مسارًا جديدًا بعد هزيمة حزب الله العام الماضي.
الحكومة الجديدة في بيروت، برئاسة القائد العسكري السابق جوزيف عون، تسعى لمنع حزب الله من إعادة التسلّح، وتعمل على ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل — وهي خطوة قد تفتح الباب لعلاقات دبلوماسية، وتنهي صراعًا دام أكثر من 75 عامًا.
أما سوريا، فالوضع فيها أكثر تقلبًا.
في الخريف الماضي، وبعد هزيمة حزب الله، ووقف إطلاق النار بوساطة أميركية في لبنان، فرّ بشار الأسد إلى موسكو مع انهيار نظامه.
الرئيس الجديد لسوريا هو أحمد الشرع، وكان سابقًا قائدًا لفصيل متمرد متطرف له صلات بتنظيم القاعدة.
كنت حينها مسؤول الملف السوري في البيت الأبيض، ودعوت للتواصل مع الشرع، لأن أولويتنا كانت إعطاء سوريا الجديدة فرصة — مع إدراكنا الكامل للمخاطر.
ومنذ ذلك الحين، قال الشرع، وفعل في معظمه، ما يكفي لإعادة سوريا إلى الحظيرة الإقليمية دون تهديد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
وقد عقد صفقات مع القوات الكردية في الشمال الشرقي، وأعاد العلاقات مع العواصم العربية، وطمأن الولايات المتحدة بما يكفي للحصول على إعفاءات من العقوبات الخانقة.
اليوم، تجري إسرائيل محادثات سرية مع سوريا، وقد يكون هناك أفق لمحادثات رسمية تؤدي إلى اتفاق عدم اعتداء.
لا شك أن مثل هذا الترتيب سيكون صعبًا، في ظل عقود من انعدام الثقة، والتوتر مع تركيا، ومتطلبات سوريا للتنازل عن موقفها من الجولان.
لكن مجرد وجود هذا الاحتمال يعكس التغيرات العميقة في المنطقة.
فبينما كانت سوريا ولبنان سابقًا ممرات رئيسية للأسلحة والميليشيات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل، أصبحتا الآن في مفاوضات سلام لترسيم الحدود وتحقيق الاستقرار.
بالنسبة لإسرائيل، فإن أرادت ترجمة نجاحها العسكري إلى مكاسب استراتيجية دائمة، فلا شيء أهم من هذا المسار الإقليمي، بما في ذلك التطبيع مع السعودية — الذي لا يزال ممكنًا خلال ولاية ترمب الثانية.
لكن ذلك يتطلب وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة، وأفقًا سياسيًا للقضية الفلسطينية، وكلاهما سيتطلب دورًا أميركيًا دبلوماسيًا نشطًا مع جميع الأطراف.
فإن كان ثمة عنصر بعيد المدى واحد على جدول أعمال لقاء ترمب ونتنياهو هذا الأسبوع — فهو هذا بالتحديد.